6 = 2 × 3 . الستة هي جداء الاثنين في ثلاثة ، فهي مضاعف لكل منهما ، أفلا تجمع بذلك فضليهما ! ... وإذا عدنا بالذاكرة إلى رموز الفيثاغوريين نجد أن العدد (2) هو رمز التضاد ، والعدد (3) هو رمز الامتداد ... أفلا يكون جداؤهما رمزا لوحدة الامتداد وضديده ؟
ولما كان الامتداد هو قرين الاتصال ، فإن ضديده هو الانفصال ... وهكذا نخلص إلى اقتراح نقدمه للفيثاغوريين يقول بكون العدد (6) رمزا لوحدة الاتصال والانفصال (أو التقطع) ... وهي إحدى تجليات الجدل الكبرى في الطبيعة .
ولا تزال في ذاكرة العلم تلك المعركة الطويلة بين (أصحاب الاتصال) و(أولي الانفصال) أو (الموجيين) و(الجسميين) حول ماهية الضوء ، والتي بدات عندما افترض العالم الإنجليزي الكبير (إسحاق نيوتن) أن الضوء هو سيالة من الجسيمات أو الكريات الضوئية ترسلها الأجسام المضيئة ، بينما رأى معاصره العالم الفيزيائي الهولندي (هيوجنز) أن الضوء ليس سوى موجات محمولة على (الأثير) تنسأ عن نبض الأجسام المضيئة (انظر : ريدنيك ، ف : ما هي ميكانيكا الكم ، دار مير ، موسكو 1971 ، ص 57) .
استمرت المعركة حت اكتشاف (ماكسويل) أن موجات الضوء ذات طبيعة كهرومغناطيسية تنشأ عن تراكب حقلين : كهربائي ومغناطيسي .
لكن الطبيعة لها رأي آخر ... فهي لا تعرف تلك اللغة (الدوغمائية) القاصرة التي اخترعها البشر : (إما .. أو) ، ولذلك اصطفت كلا من عالميها الكبيرين (ماكس بلانك) و(إلبرت آينشتاين) ليعيدا إلى التقطع وجاهته ... فالكتشف العالمان أوائل القرن العشرين أن طاقة الإشعاع الضوئي هي ذات طبيعة جسيمية متقطعة، وأنها تعطي وتُكتسب ، ليس على نحو متصل ، وإنما بوجبات أو كمّات كوانتم) ((انظر : ريدنيك ، ف : ما هي ميكانيكا الكم ، دار مير ، موسكو 1971 ) . وقد أطلق على جسيمات الطاقة فيما بعد ، اسم (الفوتونات) التي عدّت بعدئذ جسيمات الحقل الكهرومغناطيسي عامة .
وقد تجلت تلك الوحدة العميقة بين الاتصال والانفصال للشاعر أحمد شوقي حين قال :
دقات قلب المرء قائلة له * إن الحـياة دقائق وثوانِ
(7) : التجربة القرمطية :
وقد نستنطق التاريخ بحثا عن نغم سداسي الإيقاع ، فنهتدي إلى التجربة القرمطية ... ومن حق الستة أن تفخر بأنها العدد الطبيعي الوحيد الذي اقترن بالنظام السياسي والاجتماعي الفريد الذي أنشأه القرامطة في البحرين والإحساء خلال القرنيت الرابع والخامس للهجرة ... ذلك النظام الذي يشكل استثناءً في تاريخ أنظمة الحكم الإسلامية بعد الخلفاء الراشدين ، وحتى سقوط السلطنة العثمانية في القرن العشرين .
أما مكان (الستة) في هذا النظام ، فهو في مجلس (العقدانية) الذي يمثل السلطة العليا ، ويتألف من (ستة من السادة) و(ستة من الشائرة) وهم بمثابة وزراء السادة . وينتسب الفريق الأول إلى مؤسس الدولة (أبي سعيد الجنّابي) ، بينما ينتسب الفريق الآخر إلى (آل سنبر) ذوي المكانة في البحرين (انظر : لويس ، برنارد : أصول الاسماعيلية والفاطمية والقرمطية ، دارالحداثة) .
أما ما سجلة الرحالة (ناصر خسرو) في كتابه (سفرنامة) عن دولة القرامطة جدير بالمطالعة لما فيه اوصاف مثالية لهذه الدولة العظيمة (والكتاب ترجمة : يحيى الخشاب ، بيروت 1970) . ما عدا انه ذكر بأن ثروة العقدانية كانت تقوم على استثمار عمل الرقيق ، إذ كان لذلك المجلس (ثلاثون ألف عبد زنجي وحبشي ، يشتغلون بالزراعة وفلاحة البساتين (6 + × 10 +
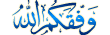
منقول للفائدة