
بيعة شرطها الجنة
رقية القضاة
يثرب تلبس ثوب الحرب البائسة، ويوم بعاث لم يمض على انقضاءه غير يسير من الزمن، والحرب الدائرة بين الأوس والخزرج، تأكل خيرة شباب القبيلتين، والفكرة التي تدور حولها الحرب غير واضحة المعالم، إنها مزيج من القبلية والجهل والتناحر، والتزاحم على السيادة والتفرد بالقوّة، وبين هذه وتلك وغيرها من محرشات الحرب الجاهلية، تبرز أصابع اليهود القذرة، وهي تضع الحطب على نار الفتنة وتزيد أوارها اشتعالاً، والخزرج تهيء لزعيمها [عبد الله بن أبيّ] تاج الملك؛ لتملكه عليها، طمعاً في أن تغدو لهم مملكة تضاهي الممالك المحيطة بالجزيرة العربية، والأوس يدركون خطورة الضعف الذي غشيهم، ويهرعون إلى مكة أملاً في التحالف مع قريش، حلفاً يقوّي شوكتهم أمام عدوّهم، الذي يشاركهم الوطن والمسكن والصّهر والدم والمصير الواحد والرزق والمخاطر الخارجية، ولكن هذه الروابط كلها بوضوحها ومنطقيتها، لم تسهم في توحيد القبيلتين، والفتنة اليهودية ماضية في توسيع الهوّة، وإذكاء نار الحقد القبلي، لكي تظل يثرب أبداً معقلاً لليهود، ووكراً تؤوي صياصيه كل أدرانهم الفاسدة، وخبائثهم المفسدة، وتمضي القافلة المتجهة إلى مكة برجال الأوس، ويطوفون بسادة مكة يسألونهم الحلف، ويأملون بالنصرة.
والرسول - صلى الله عليه وسلم - يسمع بهم ويقصدهم، عارضاً عليهم الإسلام وقد علم بما جاءوا من اجله قائلاً: (( هل لكم في خير من مما جئتم له،؟ فيتساءلون وما ذاك؟ فيقول: أنا رسول الله بعثني إلى العباد أدعوهم إلى أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئاً، وأنزل عليّ الكتاب))، ويعدّد لهم تعاليم الإسلام وفضائله، والقوم يصغون لأمر ظاهره جميل، وباطنه طيّب، ويستمعون القرآن كأندى ما يكون القول، وأرق ما تكون الديباجة، وأروع ما تبلغه رائعات المعاني، وتطمئن القلوب التي طالما روّعتها الحروب، وأنهكتها مرارة فقد الأحبّة، في حرب طاحنة حمقاء الغاية رعناء الوسيلة،، وتعلم أنّ محمّدا هو الرسول الذي طالما هدّدتهم به اليهود، وهم يظنّون أنه سيكون منهم، ويقف خطيبهم قائلاً: " قد علمت الذي بين الأوس والخزرج من الدماء، ونحن نحب ما أرشد الله به أمرك، ونحن لله ولك مجتهدون، وإنا نشير عليك بما ترى، فامكث على اسم الله حتّى نرجع إلى قومنا فنخبرهم بشأنك وندعوهم إلى الله ورسوله، فلعل الله أن يصلح بيننا، ويجمع أمرنا فإنّا اليوم متباعدون متباغضون، فإن تقدم علينا اليوم ولم نصطلح لم يكن لنا جماعة عليك"، وهم يأملون أن يجمعهم الله بعد فرقة ويوحّدهم بعد شتات، بفضل هذه الرّسالة الكاملة التي فهموها ووعوها، وعرفوا فيها سبيل الرشد والإصلاح، ولم يجدوا ذلك في غيرها من النعرات القبلية، ولا الحياة الهمجية،، ولم يعرفوه في شريعة الاستكبار والاستعلاء والاستعباد الجاهلية، وهم يهرعون إلى قومهم، يبلّغون رسالة ربهم باجتهاد، كما وعدوا نبيّهم الحبيب.
ويترقب الرّسول المشفق أنباء يثرب، إنها الأنباء التي يرجو أن تكون فيها البشرى، بأن يثرب قد غدت مهيأة لهجرته إليها، وهو يرجو ذلك لكي يأمن على نفسه وأصحابه حتى يبلّغوا رسالة الله، تلك الأمانة التي أمر بتبليغها في المنشط والمكره ولا خيار آخر له فيها، وتحمل إليه الركبان أنباء الأحبة الذين غادروه بعد ليلة العقبة الأولى مبايعين، ونشطوا لدينهم مبلغين، وهاهم يرسلون إلى الحبيب المصطفى - صلى الله عليه وسلم -، ببشارة تثلج صدره وتبعث في قلبه المحب فرحة وحنينا، وهم يطلبون إليه أن يرسل إليهم رجلاً من أصحابه بمكة، يعلّمهم دينهم ويقرئهم كتاب الله، ولم تبق دار في يثرب إلّا ودخلها الإسلام، وأسلم الكثير من الأشراف العقلاء، أولئك الذين لا يرون في الإسلام عائقاً أمام طموحاتهم، ولا يرفضون ما جاء به من المساواة بين البشر، ولا يجدون في منهجه الإصلاحي خطراً على مكتسباتهم التي حققوها بظلم الجاهلية، وفرعنة السادة، واسترقاق الأرواح الحرّة، وينطلق مصعب بن عمير فتى مكّة المنعّم، الذي انسلخ من ماله وأملاكه، ومن قبل من ربقة الشّرك، وآثر الله ورسوله والحق على ما سواهم، ينطلق مع نسمات التوحيد والبشرى المرتقبة بالنّصر المبين، يحمل في صدره كنز مكنون من الآيات الطاهرة، لينثر مسكها في فضاء يثرب، ويذرّ نداها فوق روابيها العطشى لكلمات ربّها، وشرعته العادلة، ولم تلبث يثرب أن أرسلت بركبها الميمون إلى مكة؛ لتدعوا نبيها إليها وتمنعه مما تمنع منه بنيها وأرواحها. وفي العقبة تجتمع القلوب، وتتعانق الأرواح، وتستبشر النفوس المطمئنة إلى ربّها ونبيها، محمد وصحبه الجدد، ويقف خطيب القادمين من يثرب قائلاً: " سل يا محمّد لربّك ما شئت ثمّ سل لنفسك ولأصحابك ما شئت، ثمّ أخبرنا مالنا من الثّواب على الله - عز وجل - وعليكم إذا فعلنا ذلك"، والرسول - صلى الله عليه وسلم - لا يشترط مالاً ولا جاهاً ولا دنياً، فقد سبق لقريش أن عرضت عليه الدنيا بكلّ أطيافها على أن يترك دعوة الله ولكن هيهات لهم ذاك، وها هو يجيب الأنصار قائلاً: (( أسألكم لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً، وأسألكم لنفسي ولأصحابي أن تؤونا وتنصرونا وتمنعونا ممّا منعتم منه أنفسكم، فقالوا: وما لنا إن فعلنا ذلك؟ قال: لكم الجنّة، قالوا: فلك ذاك))، ويرجع الركب المبايع على النصرة والفداء وقد خلفوا قلوبهم في مكة تترقب يوم قدومه إلى يثرب بالعدل والنور والعزّة والهداية، وكلّهم عزم وتصميم على المضيّ قدما، في سبيل نصرة الدّين الذي اعتنقوه عن قناعة بخيريته ورحمته وفضله العميم، فقد وافقت مبادئ هذا الدين ما فطروا عليه من الحريّة والكرم والنّخوة، والامتناع على كل باغ وغاز ومحارب، صفات شهد لهم بها كل ما حولهم من قبائل العرب، وهو فوق هذا وذاك، يحثّ على المكارم والطيّبات التي انطوت عليها نفوسهم الكريمة، فكانت استجابتهم لله ولرسوله أسرع وأعمق ممن سواهم، وهاهي يثرب تستعد لاستقبال الكوكبة تلو الأخرى من فرسان الحق وجنده الذين باعوا الدنيا بما فيها، وخرجوا حاملين معهم مشعل الهدى، يسبقون رسولهم إلى يثرب التي ستغدوا بعد هجرته إليها طيبة الطيّبة، والتي ستصير بمدنيّة الإسلام، وحضارته، وشموليته مركزا للحضارة والحريّة والانتصار العادل، وتحمل إلى الأبد اسما تمتزج فيه معالم الهداية بفيض النور، وتأتلق في حروفه شذرات المسك، ونفحات الطيب اسما ظلّ على مدى الأيام ملكا لها وحدهاالمدينة المنوّرة
م/ن..
 أنت غير مسجل في مملكة الدالي للروحانيات والحكمة *** الكشف والعلاج المجاني والمتابعة وعلاج كل الامراض الروحية eddouali@hotmail.com = 0021698814085 . للتسجيل الرجاء إضغط هنـا
أنت غير مسجل في مملكة الدالي للروحانيات والحكمة *** الكشف والعلاج المجاني والمتابعة وعلاج كل الامراض الروحية eddouali@hotmail.com = 0021698814085 . للتسجيل الرجاء إضغط هنـا
 أنت غير مسجل في مملكة الدالي للروحانيات والحكمة *** الكشف والعلاج المجاني والمتابعة وعلاج كل الامراض الروحية eddouali@hotmail.com = 0021698814085 . للتسجيل الرجاء إضغط هنـا
أنت غير مسجل في مملكة الدالي للروحانيات والحكمة *** الكشف والعلاج المجاني والمتابعة وعلاج كل الامراض الروحية eddouali@hotmail.com = 0021698814085 . للتسجيل الرجاء إضغط هنـا



 الإهداءات
الإهداءات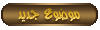




















 المواضيع المتشابهه
المواضيع المتشابهه



